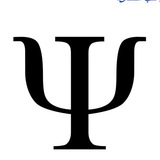النضج (: Maturity) في علم النفس، هو القدرة على الاستجابة للبيئة بطريقة مناسبة. وهذه الاستجابة عموما متعلمة وليست غريزية. ويشمل النضج أيضا أن يكون الفرد على وعي بالوقت والمكان المناسبين للسلوك، وكذلك معرفة متى يتصرف الفرد، وفقا لظروف وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه. تشمل نظريات نمو ونضج الكبار مطلح "المغزى" في مفهوم الحياة، حيث أن النضج يؤكد على فهم واضح لمغزى الحياة، والتوجيه، والتعمد، مما يسهم في الشعور بأن الحياة ذات مغزى معين.
تتميز حالة النضج بالانتقال من الاعتماد على الوصاية والإشراف (من قبل آخرين) علي اتخاذ القرارات. وللنضج تعاريف مختلفة في سياقات قانونية واجتماعية ودينية وسياسية وجنسية وعاطفية وفكرية. ويرتبط السن أو الصفات المميزة لكل من هذه السياقات بمؤشرات استقلالية ذات أهمية ثقافية غالبا ما تتفاوت نتيجة المشاعر الاجتماعية. ومفهوم النضج النفسي له انعكاسات على السياقات القانونية والاجتماعية، في حين أن مزيج من النشاط السياسي والأدلة العلمية لا تزال تعيد تشكيل تعريفه وتأهيله. وبسبب هذه العوامل، فإن مفهوم وتعريف النضج وعدم النضج يعتبر غير موضوعي إلى حد ما.
اقترح عالم النفس الأمريكي جيروم برونر (Jerome Bruner) الغرض من فترة عدم النضج على أنه وقت للعب التجريبي دون عواقب وخيمة، حيث يمكن للحيوان الصغير أن يمضي قدرا كبيرا من الوقت في مراقبة أعمال الآخرين الماهرين بالتنسيق مع وإشراف الأم. وبالتالي، فإن مفتاح الابتكار البشري من خلال استخدام الرموز والأدوات هو المحكاة التفسرية والتي هي "ممارسة وإتقان اللعب" من خلال استكشاف واسع النطاق للحدود على قدرة المرء على التفاعل مع العالم. وقد افترض علماء النفس التطوريون أيضا أن عدم النضج المعرفي قد يخدم غرضا تكيفيا كحواجز وقائية للأطفال ضد نقص قدراتهم المعرفية، والتعرضية التي يمكن أن تضعهم في طريق الأذى. بالنسبة للشباب اليوم، فإن الفترة الممتدة بشكل مطرد من "اللعب" والتعليم المدرسي في القرن الحادي والعشرين تأتي نتيجة للتعقيد المتزايد لعالمنا وتكنولوجياته، الأمر الذي يتطلب أيضا تعقيدا متزايدا في المهارات وكذلك أكثر مجموعة شاملة من القدرات المسبقة. قد تنشأ العديد من المشاكل السلوكية والعاطفية المرتبطة بالمراهقة عندما يتكيف الأطفال مع المطالب المتزايدة المفروضة عليهم، والمطالب التي أصبحت مستخرجة بشكل متزايد من خلال عمل وتوقعات سن البلوغ.
اقترح عالم النفس الأمريكي جيروم برونر (Jerome Bruner) الغرض من فترة عدم النضج على أنه وقت للعب التجريبي دون عواقب وخيمة، حيث يمكن للحيوان الصغير أن يمضي قدرا كبيرا من الوقت في مراقبة أعمال الآخرين الماهرين بالتنسيق مع وإشراف الأم. وبالتالي، فإن مفتاح الابتكار البشري من خلال استخدام الرموز والأدوات هو المحكاة التفسرية والتي هي "ممارسة وإتقان اللعب" من خلال استكشاف واسع النطاق للحدود على قدرة المرء على التفاعل مع العالم. وقد افترض علماء النفس التطوريون أيضا أن عدم النضج المعرفي قد يخدم غرضا تكيفيا كحواجز وقائية للأطفال ضد نقص قدراتهم المعرفية، والتعرضية التي يمكن أن تضعهم في طريق الأذى. بالنسبة للشباب اليوم، فإن الفترة الممتدة بشكل مطرد من "اللعب" والتعليم المدرسي في القرن الحادي والعشرين تأتي نتيجة للتعقيد المتزايد لعالمنا وتكنولوجياته، الأمر الذي يتطلب أيضا تعقيدا متزايدا في المهارات وكذلك أكثر مجموعة شاملة من القدرات المسبقة. قد تنشأ العديد من المشاكل السلوكية والعاطفية المرتبطة بالمراهقة عندما يتكيف الأطفال مع المطالب المتزايدة المفروضة عليهم، والمطالب التي أصبحت مستخرجة بشكل متزايد من خلال عمل وتوقعات سن البلوغ.
العلامات الاجتماعية-العاطفية والمعرفية
على الرغم من أن النضج النفسي يستند تحديدا على الاستقلالية في القدرة علي اتخاذ القرارات، إلا أن هذه النتائج ليست متضمَنة في الإدراك وحسب، بل أيضا في عمليات التطور العاطفي والاجتماعي والأخلاقي مدى الحياة. وقد قدم العديد من المنظرين إطارات للاعتراف بمؤشرات النضج. وتصف مراحل إريكسون للتطور النفسي والاجتماعي التقدم لمرحلة النضج في البالغين، حيث تتميز كل مرحلة من مراحل النضج بنوع معين من الصراعات النفسية-الاجتماعية. وتتميز مرحلة "الهوية" بأنها تتعلق أساسا بقضايا استكشاف الأدوار والارتباك في الأدوار، وكذلك استكشاف الهوية الجنسية والهويات الأخرى. ويتجول المراهقون في شبكة من القيم المتضاربة من أجل الظهور كـ "شخص حان وقته" و "الشخص الذي يتوقعه المجتمع". ولم يصر إريكسون على أن المراحل تبدأ وتنتهي بنقاط محددة مسبقا بشكل عام، ولكن هناك مراحل معينة مثل "الهوية" يمكن أن تمتد إلى مرحلة البلوغ لطالما استغرقت الوقت في حل الصراع. تعرف نظرية بياجيه للتطور المعرفي المرحلة التشغيلية الرسمية كمنصة يمكن الوصول إليها بمجرد أن يكون الفرد قادرا علي التفكير منطقيا باستخدام الرموز، ويتسم بالتحول البعيد عن الفكر "الملموس" (المادي)، أو الفكر المرتبط بالواقع والحقائق، نحو الفكر "المجرد"، أو الفكر الذي يستخدم الانعكاس والاستنتاج. وقد شكلت هذه النظريات التحقيق في تنمية المراهقين وتعكس قيود الإدراك قبل سن البلوغ.
في الوقت الذي يُطلق النضج النفسي في كثير من الأحيان على أنه تسمية يتم منحها للطفل، فقد كشفت الأبحاث أن الأطفال أنفسهم لديهم شعور واضح باستقلالهم الذاتي وولايتهم الشخصية. على سبيل المثال، أظهر أطفال المدارس في سن المدرسة الابتدائية الأمريكية اعترافا بحدود سلطة والديهم على اختيارهم للملابس، وتسريحة الشعر، والأصدقاء، والهوايات، والخيارات الإعلامية. لكن هذا الأمر قد قيّد من المفهوم السابق للاستقلالية الشخصية في وقت لاحق تطور إلى فهم أوسع للحريات الفردية، مع فهم حرية التعبير كحق عالمي مستحق بوصول سن المدرسة الابتدائية. ومع ذلك، يواجه الأطفال الأصغر سنا صعوبة في الحفاظ على وجهة نظر متسقة بشأن الحقوق العالمية، حيث يعبر 75٪ من أطفال الصف الأول عن بالشك بشأن حظر حرية التعبير في كندا. ولكن هذه الدراسة نفسها وجدت أيضا أن الأطفال الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عاما قد رفضوا الأنظمة غير الديمقراطية على أساس انتهاك مبادئ تصويت الأغلبية والتمثيل المتساوي والحق في التعبير، مما يوفر دليلا على المعرفة الناشئة بمهارات صنع القرار السياسي منذ سن مبكر.
على الرغم من أن النضج النفسي يستند تحديدا على الاستقلالية في القدرة علي اتخاذ القرارات، إلا أن هذه النتائج ليست متضمَنة في الإدراك وحسب، بل أيضا في عمليات التطور العاطفي والاجتماعي والأخلاقي مدى الحياة. وقد قدم العديد من المنظرين إطارات للاعتراف بمؤشرات النضج. وتصف مراحل إريكسون للتطور النفسي والاجتماعي التقدم لمرحلة النضج في البالغين، حيث تتميز كل مرحلة من مراحل النضج بنوع معين من الصراعات النفسية-الاجتماعية. وتتميز مرحلة "الهوية" بأنها تتعلق أساسا بقضايا استكشاف الأدوار والارتباك في الأدوار، وكذلك استكشاف الهوية الجنسية والهويات الأخرى. ويتجول المراهقون في شبكة من القيم المتضاربة من أجل الظهور كـ "شخص حان وقته" و "الشخص الذي يتوقعه المجتمع". ولم يصر إريكسون على أن المراحل تبدأ وتنتهي بنقاط محددة مسبقا بشكل عام، ولكن هناك مراحل معينة مثل "الهوية" يمكن أن تمتد إلى مرحلة البلوغ لطالما استغرقت الوقت في حل الصراع. تعرف نظرية بياجيه للتطور المعرفي المرحلة التشغيلية الرسمية كمنصة يمكن الوصول إليها بمجرد أن يكون الفرد قادرا علي التفكير منطقيا باستخدام الرموز، ويتسم بالتحول البعيد عن الفكر "الملموس" (المادي)، أو الفكر المرتبط بالواقع والحقائق، نحو الفكر "المجرد"، أو الفكر الذي يستخدم الانعكاس والاستنتاج. وقد شكلت هذه النظريات التحقيق في تنمية المراهقين وتعكس قيود الإدراك قبل سن البلوغ.
في الوقت الذي يُطلق النضج النفسي في كثير من الأحيان على أنه تسمية يتم منحها للطفل، فقد كشفت الأبحاث أن الأطفال أنفسهم لديهم شعور واضح باستقلالهم الذاتي وولايتهم الشخصية. على سبيل المثال، أظهر أطفال المدارس في سن المدرسة الابتدائية الأمريكية اعترافا بحدود سلطة والديهم على اختيارهم للملابس، وتسريحة الشعر، والأصدقاء، والهوايات، والخيارات الإعلامية. لكن هذا الأمر قد قيّد من المفهوم السابق للاستقلالية الشخصية في وقت لاحق تطور إلى فهم أوسع للحريات الفردية، مع فهم حرية التعبير كحق عالمي مستحق بوصول سن المدرسة الابتدائية. ومع ذلك، يواجه الأطفال الأصغر سنا صعوبة في الحفاظ على وجهة نظر متسقة بشأن الحقوق العالمية، حيث يعبر 75٪ من أطفال الصف الأول عن بالشك بشأن حظر حرية التعبير في كندا. ولكن هذه الدراسة نفسها وجدت أيضا أن الأطفال الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عاما قد رفضوا الأنظمة غير الديمقراطية على أساس انتهاك مبادئ تصويت الأغلبية والتمثيل المتساوي والحق في التعبير، مما يوفر دليلا على المعرفة الناشئة بمهارات صنع القرار السياسي منذ سن مبكر.
النضج الفكري ليس بالظبط ان يكّون يعرف ماذا يفعله ، وإنما مخطط لكل شيء ؟
النضج الفكري ليس بالظبط ان يكون مثقف وإنما واعي ايضاً ، يوجد الكثير من المثقفين لكن بدون وعي.
النضج الفكري ليس بالشرط ان يكون الشخص مثقف ، يجب ان يعرف كل شيء سخيف وكل شيء نقي ، يجب ان يختلط مع الناس ويعرف ماذا يفعل !
متلازمة ستوكهولم هي ظاهرة نفسية التي تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المخطوف مع المُختَطِف. وتسمى أيضاً برابطة الأسر أو الخطف وقد اشتهرت في العام 1973 حيث تظهر فيها الرهينة أو الاسيرة التعاطف والانسجام والمشاعر الايجابية تجاه الخاطف أو الآسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه . هذه المشاعر تعتبر بشكل عام غير منطقية ولا عقلانية في ضوء الخطر والمجازفة التي تتحملها الضحية، إذ أنها تفهم بشكل خاطىء عدم الاساءة من قبل المعتدي احساناً ورحمة. وقد سجلت ملفات الشرطة وجود متلازمة ستوكهولم لدى 8% من حالات الرهائن.
ويمكن اعتبار متلازمة ستوكهولم كنوع من الارتباط الذي له علاقة بالصدمة، ولا يتطلب بالضرورة وجود حالة خطف، فهو ترابط عاطفي قوي يتكون بين شخصين أحدهما يضايق ويعتدي ويهدد ويضرب ويخيف الآخر بشكل متقطع ومتناوب.
إحدى الفرضيات التي تفسر هذا السلوك، تفترض ان هذا الارتباط هو استجابة الفرد للصدمة وتحوله لضحية. فالتضامن مع المعتدي هو إحدى الطرق للدفاع عن الذات. فالضحية حين تؤمن بنفس افكار وقيم المعتدي فان هذه الافكار والتصرفات لن تعتبرها الضحية تهديدا أو تخويفا. وقد يطلق على متلازمة ستوكهولم خطئاً اسم متلازمة هلسنكي
أطلق على هذه الحالة اسم "متلازمة ستوكهولم" نسبة إلى حادثة حدثت في ستوكهولم في السويد حيث سطا مجموعة من اللصوص على بنك كريديتبانكين Kreditbanken هناك في عام 1973، واتخذوا بعضاً من موظفي البنك رهائن لمدة ستة أيام، خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفياً مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.
ويمكن اعتبار متلازمة ستوكهولم كنوع من الارتباط الذي له علاقة بالصدمة، ولا يتطلب بالضرورة وجود حالة خطف، فهو ترابط عاطفي قوي يتكون بين شخصين أحدهما يضايق ويعتدي ويهدد ويضرب ويخيف الآخر بشكل متقطع ومتناوب.
إحدى الفرضيات التي تفسر هذا السلوك، تفترض ان هذا الارتباط هو استجابة الفرد للصدمة وتحوله لضحية. فالتضامن مع المعتدي هو إحدى الطرق للدفاع عن الذات. فالضحية حين تؤمن بنفس افكار وقيم المعتدي فان هذه الافكار والتصرفات لن تعتبرها الضحية تهديدا أو تخويفا. وقد يطلق على متلازمة ستوكهولم خطئاً اسم متلازمة هلسنكي
أطلق على هذه الحالة اسم "متلازمة ستوكهولم" نسبة إلى حادثة حدثت في ستوكهولم في السويد حيث سطا مجموعة من اللصوص على بنك كريديتبانكين Kreditbanken هناك في عام 1973، واتخذوا بعضاً من موظفي البنك رهائن لمدة ستة أيام، خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفياً مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.
السمات العامه :
لكل متلازمة اعراض وسلوكيات تميزها، ولعدم الاتفاق على قائمة متكاملة من الأعراض لاختلاف آراء الباحثين والمتخصصين، لكن بعض العلامات لابد من تواجدها ضمن متلازمة ستوكهولم مثل:
المشاعر الايجابية تجاه المعتدي المتسلط
المشاعر السلبية للضحية تجاه العائلة أوالاصدقاء أو من يحاول إنقاذهم أو الوقوف بجانبهم.
دعم وتأييد سلوك وتفكيرالمعتدي
المشاعر الايجابية للمعتدي تجاه الضحية
سلوكيات ساندة للمعتدي من قبل الضحية واحياناً مساعدة المعتدي
عدم القدرة على المشاركة في أي سلوك يساعد على تحرير الضحية أو فك ارتباطها.
لكل متلازمة اعراض وسلوكيات تميزها، ولعدم الاتفاق على قائمة متكاملة من الأعراض لاختلاف آراء الباحثين والمتخصصين، لكن بعض العلامات لابد من تواجدها ضمن متلازمة ستوكهولم مثل:
المشاعر الايجابية تجاه المعتدي المتسلط
المشاعر السلبية للضحية تجاه العائلة أوالاصدقاء أو من يحاول إنقاذهم أو الوقوف بجانبهم.
دعم وتأييد سلوك وتفكيرالمعتدي
المشاعر الايجابية للمعتدي تجاه الضحية
سلوكيات ساندة للمعتدي من قبل الضحية واحياناً مساعدة المعتدي
عدم القدرة على المشاركة في أي سلوك يساعد على تحرير الضحية أو فك ارتباطها.
الاسباب :
تفسير متلازمة ستوكهولم طبقاً لـعلم النفس التطوري يفسر التعاطف والارتباط مع الخاطف بأنه حل لمشكلة تعايش الضحية مع وضع تكون فيه مسلوبة الارادة ومغلوبة على أمرها للحفاظ على حياتها وبقائها وهو معروف منذ اقدم العصور. فإحدى المشاكل التي كانت تواجه النساء في المجتمعات البدائية هي التعرض للخطف أو الأسر من قبل قبيلة أخرى، فخطف النساء واغتصابهن وقتل اطفالهن الصغار كان أمراً شائعاً وكانت المرأة التي تقاوم في تلك المواقف تعرض حياتها للخطر. وخلال فترات طويلة من التاريخ كان خوض الحروب واخذ السبايا أمراً طبيعياً وقد كانت السبية أو الأسيرة تتعايش وتندمج ضمن القبيلة التي أسرتها وتخلص لها. هذا النمط من الحياة ما زال معروفاً لدى بعض القبائل البدائية .
ومازالت هناك انواع من العلاقات في الوقت الحاضر تحمل بعض السمات النفسية للارتباط مع الخاطف أو الآسر مثل متلازمة الزوجة المتعرضة للضرب، والعلاقة خلال التدريبات العسكرية الاولية، وضمن الأخويات أو نوادي الرجال، وكذلك في بعض الممارسات الجنسية كالسادية والماسوشية أو الارتباط والعقاب .
تفسير متلازمة ستوكهولم طبقاً لـعلم النفس التطوري يفسر التعاطف والارتباط مع الخاطف بأنه حل لمشكلة تعايش الضحية مع وضع تكون فيه مسلوبة الارادة ومغلوبة على أمرها للحفاظ على حياتها وبقائها وهو معروف منذ اقدم العصور. فإحدى المشاكل التي كانت تواجه النساء في المجتمعات البدائية هي التعرض للخطف أو الأسر من قبل قبيلة أخرى، فخطف النساء واغتصابهن وقتل اطفالهن الصغار كان أمراً شائعاً وكانت المرأة التي تقاوم في تلك المواقف تعرض حياتها للخطر. وخلال فترات طويلة من التاريخ كان خوض الحروب واخذ السبايا أمراً طبيعياً وقد كانت السبية أو الأسيرة تتعايش وتندمج ضمن القبيلة التي أسرتها وتخلص لها. هذا النمط من الحياة ما زال معروفاً لدى بعض القبائل البدائية .
ومازالت هناك انواع من العلاقات في الوقت الحاضر تحمل بعض السمات النفسية للارتباط مع الخاطف أو الآسر مثل متلازمة الزوجة المتعرضة للضرب، والعلاقة خلال التدريبات العسكرية الاولية، وضمن الأخويات أو نوادي الرجال، وكذلك في بعض الممارسات الجنسية كالسادية والماسوشية أو الارتباط والعقاب .
الدولة القمعية
وعلى صعيد المجتمع، يمكن ملاحظة هذا التأثير في الأنظمة القمعية، عندما لا تملك السلطة شرعيتها من أغلبية الشعب، فتصبح وسيلة الحكم القمعية ضاغطة على افراد المجتمع، ولمدة طويلة، يطور خلالها الافراد علاقة خوف من النظام، فيصبح المجتمع ضحية النظام، ويدرك النظام هذه الحالة مع الوقت، حتى يتقن لعبة ابتزاز المجتمع. فيعتاد الشعب على القمع والذل لدرجه تجعله يخشى من التغيير حتى وإن كان للأفضل ويظل يدافع عن النظام القمعى ويذكر محاسنه القليله جدا دون الإلتفتات إلى مظاهر القمع والفساد الكثيرة.
وعلى صعيد المجتمع، يمكن ملاحظة هذا التأثير في الأنظمة القمعية، عندما لا تملك السلطة شرعيتها من أغلبية الشعب، فتصبح وسيلة الحكم القمعية ضاغطة على افراد المجتمع، ولمدة طويلة، يطور خلالها الافراد علاقة خوف من النظام، فيصبح المجتمع ضحية النظام، ويدرك النظام هذه الحالة مع الوقت، حتى يتقن لعبة ابتزاز المجتمع. فيعتاد الشعب على القمع والذل لدرجه تجعله يخشى من التغيير حتى وإن كان للأفضل ويظل يدافع عن النظام القمعى ويذكر محاسنه القليله جدا دون الإلتفتات إلى مظاهر القمع والفساد الكثيرة.
هذا أنا ....
أنا لست على ما يُرام ، أنا مريض و هذا المرض يؤلمني حقاً .
حيث أنني لا أستطيع فهمي و لا حتى أن أصمت ، و إن أردت الصمت أفكاري تُزعجني و تؤلم رأسي ، أنا مُتناقض ، أريد شيئاً و لكن لا أريده ، لم أفهمني قط و لكنني حاولت جاهداً بهذه المصيبة.
أنا مُتعجرف و حزين و تعيس ، أنا مُتشتت و لا أفهم ماذا بي ، أنام و أنا أبكي و في صحوتي أبتسم و كأن شيئاً لم يكن .
أنا الذي يُمثل أنه قوي و صُلب و لكنني "هش" ، أنا غير اجتماعي ، أنا مُنعزل و أكثر وقتي أُحدث الناس و كأنني أعرفهم و أنا عكس ذلك لا أُطيقهم أبداً .
أنا خبيث كـ خُبث الشيطان و لكنني أُجيد تمثيل دور الملاك دائماً.
أنا لست على ما يُرام ، أنا مريض و هذا المرض يؤلمني حقاً .
حيث أنني لا أستطيع فهمي و لا حتى أن أصمت ، و إن أردت الصمت أفكاري تُزعجني و تؤلم رأسي ، أنا مُتناقض ، أريد شيئاً و لكن لا أريده ، لم أفهمني قط و لكنني حاولت جاهداً بهذه المصيبة.
أنا مُتعجرف و حزين و تعيس ، أنا مُتشتت و لا أفهم ماذا بي ، أنام و أنا أبكي و في صحوتي أبتسم و كأن شيئاً لم يكن .
أنا الذي يُمثل أنه قوي و صُلب و لكنني "هش" ، أنا غير اجتماعي ، أنا مُنعزل و أكثر وقتي أُحدث الناس و كأنني أعرفهم و أنا عكس ذلك لا أُطيقهم أبداً .
أنا خبيث كـ خُبث الشيطان و لكنني أُجيد تمثيل دور الملاك دائماً.
استمتعت كثيراً ب وجودكم في القناة ، الان سأحذف القناة وسأحذف
الحساب ، شكراً لكل من حادثتي وأعطاني كلام محفز ، لكل من عرفته من القناة ، يوجد الكثير من المرضى أتمنى لكم الشفاء ، اعذروني ان فعلت شيء سيّء او قصرت
. ، انا انسان عصبي ومنهار عصبياً ومتدهور وواقع في الحيرة ولا يمكني الاستمرارية
....
سأحذف القناة الان ، ان كُنتُم ترغبون بشيء ابعثوا رسالة في الانستغرام “20_01_0”
شكراً لكم مره اخرى
🍃
الحساب ، شكراً لكل من حادثتي وأعطاني كلام محفز ، لكل من عرفته من القناة ، يوجد الكثير من المرضى أتمنى لكم الشفاء ، اعذروني ان فعلت شيء سيّء او قصرت
. ، انا انسان عصبي ومنهار عصبياً ومتدهور وواقع في الحيرة ولا يمكني الاستمرارية
....
سأحذف القناة الان ، ان كُنتُم ترغبون بشيء ابعثوا رسالة في الانستغرام “20_01_0”
شكراً لكم مره اخرى
🍃
Psychology and Neurology
https://t.me/Psychology_Neurology1
القناه الجديده ، هاي القناه رح تنمسح
من فضلكم انضموا للقناه الجديده 🌸
من فضلكم انضموا للقناه الجديده 🌸
Psychology and Neurology pinned «القناه الجديده ، هاي القناه رح تنمسح من فضلكم انضموا للقناه الجديده 🌸»